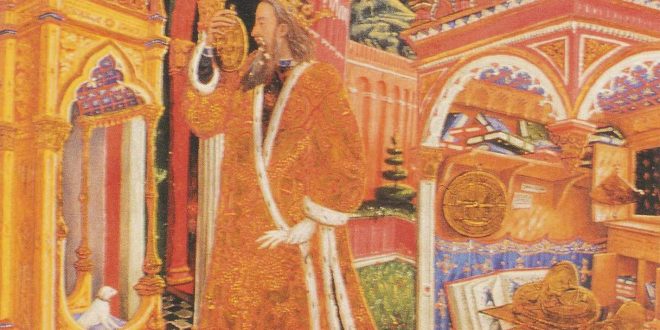قسم علماء التراث والحضارات القديمة الشعوب التي سكنت المنطقة التي نسميها الآن منطقة الشرق العربي إلى عدة حضارات. فكان منها الفينقيين والسومريين والاكاديين والبابليين و الآشوريين والعبريين والفرس والكلدانيين والكنعانيين والمصريين. ويرى بعض هؤلاء العلماء أن هذه الحضارات إنما هي حضارات منفصلة و غالبا لا تمت بصلة إلى الآخرى. ولكن في الدراسات المعاصرة والتي إعتمدت على فقه اللغة أساسا لها فترى أن أصل اللغة عند كل هذه الحضارات إنما هو أصل واحد وهي اللغة العربية القديمة. وإن إختلاف اللغة بين هذه الحضارات إنما هو في إختلاف اللهجات فيما بينها وبذلك يكون أصل كل هذه الحضارات واحد, تتكلم لغة واحدة في لهجات سميت باللهجات العربية. وترى هذه الدراسات أيضاً أن إختلاف اللهجة أو إختلاف طرق الكتابة لهذه اللهجات لا يعني أن هذه لغات مختلفة. فقد كتبت العربية بعدة طرق وعدة أحرف ولكن الأصل واحد. فلهذه الدراسات إنعكاس مهم في دراسة تاريخ هذه الشعوب القديمة وصولاً إلى تاريخ علم الفلك عند العرب والمسلمين. فالتفاعل الثقافي بين الشعوب لا ينقطع بمرور الزمن وإن كان يمر أحيانا بمد أو جزر حسب الظروف الإقتصادية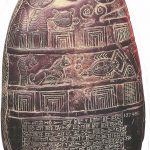 والإجتماعية والفكرية بينها. وحين ندرك أن شعوب أو حضارات منطقتنا العربية إنما هي عدة فروع لأصل واحد ندرك مدى إندماج و تواصل العلوم والمبادئ والعقائد بين هذه الحضارات المتعددة.
والإجتماعية والفكرية بينها. وحين ندرك أن شعوب أو حضارات منطقتنا العربية إنما هي عدة فروع لأصل واحد ندرك مدى إندماج و تواصل العلوم والمبادئ والعقائد بين هذه الحضارات المتعددة.
لقد إهتم سكان هذه الحضارات في منطقة الشرق العربي بأحكام النجوم والفلك منذ القدم. فعرفوا الكواكب السيارة وفسروا دورة القمر كما إستخدم البابليون النظام الستيني فقسموا محيط الأرض والفلك إلى دائرة من 360 درجة وقسموا اليوم إلى قسمين كل قسم 12 ساعة للنهار و12 ساعة لليل. كما عرفوا الخسوف والكسوف وإستخدموا الساعات الشمسية والمائية لقياس الزمن. كما برع البابليون في رصد الكواكب وصنعوا عدة الآلات فلكية لرصدها مثل الإسطرلاب. و برع الكلدانيون أيضا في علم الفلك فقسموا الإسبوع إلى سبعة أيام وربطوا أيام الإسبوع بالشمس والقمر والكواكب الخمسة المعروفة آنذاك وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل. وأما المصريين (الفراعنة) فقد تمكنوا من قياس طول السنة الشمسية وعرفوا أنها تساوي 365.25 يوم وإستخدموا حركة الشمس ومواقع النجوم والكواكب في التقويم.
ويمتد تاريخ هذه الحضارات من 6000 سنة قبل الميلاد وحتى 600 ق.م. حين ظهرت الحضارة اليونانية وسيطرت على المنطقة وبذلك كانت هي الأقوى في تأثير متواصل بينها وبين حضارات شعوب منطقة الشرق العربي. فقد تأثر كثيرا من علماء اليونان بالعلوم الفلكية وبالاخص البابلية كأمثال فيثاغورس Pythagoras وغيره. وكان للإغريق إهتمام واسع في علم الفلك فطوروا أساليب الرصد ووضعوا قوانين ونظريات في حركات الكواكب والنجوم. فكان منهم الفلاسفة والعلماء من أمثال: طاليس، أفلاطون، أرسطو ، هيبارخوس حتى بطلميوس الذي وضع عدة كتب في الفلك ومن أشهرها وأهمها كتاب المجسطي الذي إشتمل على كافة مواضيع وفروع علوم الفلك وأسراره وعلم حركات الكواكب و النجوم. فكان لهذا الكتاب تأثيرا كبيرا على تفكير علماء الفلك العرب و المسلمين لمدة عشرة قرون فكان واحدا من أهم الكتب الفلكية التي تم ترجمتها عدة مرات إلى اللغة العربية في بداية العصر العباسي.
من المتعارف عليه ان القبائل العربية قبل الإسلام سميت بعرب الجاهلية وفي رجوعنا إلى دراسة فقه اللغات العربية ندرك أن أهم هذه القبائل إنما هي القبائل العدنانية التي تتكلم باللهجة العربية العدنانية والتي نعرفها اليوم بالعربية الفصحى. وندرك أيضا أن هذه القبائل إنما هي إمتداد لحضارات المنطقة والتي منها برزت الحضارات القديمة الكبيرة مثل البابلية والاكادية … الخ والتي تتكلم لغة واحدة ولكن بلهجات مختلفة. فكثيرا ما يستغرب على عرب الجزيرة العربية أنهم كانوا على علم بالمعارف الفلكية. وأنه كان لهم معرفة لعدد من القوانين الفلكية مثل الشهر القمري والسنة الشمسية وحركات النجوم. فينسبون معرفتهم لتلك العلوم فقط لسد حاجاتهم العملية والتي تساعدهم بالإهتداء ليلاً في الصحراء وأنهم أخذوا هذه العلوم من الشعوب المجاورة كالفرس و الهنود والتي يرجع الفضل إليهم في تأسيس علم النجوم.
صحيح أن عرب الجاهلية لم يكن عندهم دراسات منظمة عن حركة ومواقع النجوم السماوية ولم يستخدموا الرياضات في الفلك ولم يستخدموا الآت وأجهزة الرصد الفلكي ولكن من خلال المعلومات عن علومهم الفلكية وأسماء التشكيلات النجمية وتحديد لمعان النجوم ولونها وتسميتها والتي تدل على جهة النجم وموقعه إنما تدلنا أن على مدى العصور كان لهذه القبائل العربية إطلاع جيد على العلوم الفلكية كما كان لهم إتصال دائم بالحضارات المجاورة وإختلاط بشعوب بلاد وادي الرافدين وأهل الشام وحضارة الفرس والمصريين الفراعنة.
لكن العرب القدماء إستطاعوا أيضا أن يطوروا علما خاصا بهم و يدعي “علم الأنواء” و الذي إنفردوا فيه عن بقية الشعوب القديمة المجاورة وحتى عن الفرس و الهنود. فكان للعرب إهتماما واسعا بحركة النجوم و الشمس و القمر. وكان القمر بالنسبة اليهم أهم ظاهرة فلكية على الإطلاق حتى ان بعضهم وصل الى حد عبادته. فقسم عرب الجزيرة العربية حركة القمر اليومية خلال الشهر القمري الى ثمان و عشرون موقعا او منزلة يبقى القمر فيها ليلة واحدة. كما قسموا مسار الشمس الظاهري و التي تعرف بدائرة البروج الى الثمان و العشرون منزلة نفسها محددة بنجم مثل الدبران او بمجموعة من النجوم مثل الثريا. وتبعد هذه المنازل عن بعضها البعض بمسافات شبه متساوية كما كانوا يرونها بالعين المجردة. و هذه المنازل هي: الشرطان, البطين, الثريا, الدبران, الهقعة, الهنعة, الذراع, النثرة, الطرق, الجبهة, الزبرة, الصرفة, العواء, الرشا, المؤخر, المقدم, سعد الاخبية, سعد السعود, سعد بلع, سعد الذابح, البلدة, النعايم, الشولة, القلب, الإكليل, الزبانا, الغفر, السماك . فمن خلال هذه المنازل إستطاعوا ان يحددوا أوقات الفصول و أحوال الطقس. فكانوا يعتبرون ان لكل منزلة من هذه المنازل حالة طقس خاصة, اما برد ا و حر او مطر. فكانت تنسب حالة الطقس الى منزلة النجم او المجموعة النجمية التي تحل بها الشمس في تلك الفترة. وخلد العرب القدماء هذه العلوم في أشعارهم و سجعهم ليتنلقلوها جيلا من بعد جيل.
و حر او مطر. فكانت تنسب حالة الطقس الى منزلة النجم او المجموعة النجمية التي تحل بها الشمس في تلك الفترة. وخلد العرب القدماء هذه العلوم في أشعارهم و سجعهم ليتنلقلوها جيلا من بعد جيل.
وكان عرب الجزيرة العربية القدماء يؤرخون بالأشهر القمرية فكانت السنة القمرية مكونة من 12 شهرا لكنهم كانوا قد ايقنوا ان السنة القمرية أقصر من السنة الشمسية بحوالي 11 يوما. فالسنة القمرية لا تتفق مع فصول السنة وبذلك تختلف المناسبات و الأعياد من عام الى عام. فلجوا الى زيادة 11 يوما في نهاية كل عام و التي سميت “بأيام النسيء” . و أوكلوا تحديد أيام النسيء الى فئة مختصة لضبط التقاويم. لكن التأخير و التقديم و تلاعب “النسأة” في تحديد الأشهر حسب رغبتهم جعل التقويم فوضى حتى جاء الإسلام فحرم النسيء. و إستعمل الإسلام هذا التقويم القمري العربي نفسه و هو ما يعرف بالتقويم الهجري المعتمد حاليا في البلاد الإسلامية.
 علم و عالم
علم و عالم